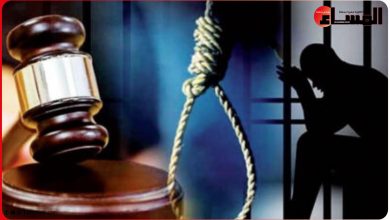شهادة التاريخ في حقّ الرَّاحل خالد بوزوبع

أستاذ بشعبة الفلسفة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز فاس.
بمناسبة الندوة التكريمية التي عقدت بشعبة الفلسفة 29/30 نونبر/ تشرين الثاني، 2024
نحن نقوم بتكريم المفكرين والزملاء والأساتذة اعترافًا بمنجزاتهم العلمية ومساهماتهم التربوية في تكوين الأجيال. يوجد فرق واضح بين تكريم الزملاء في حياتهم وتكريم الزملاء بعد وفاتهم.يحظى تكريم الزملاء بعد وفاتهم بطعم خاص، بنكهة خاصة وله تأثير كبير على أسرة الفقيد وعلى طلبته السابقين وعلى زملائه الذين عرفوه، لأننا نكتشف ما معنى وفاة الزميل بعد مرور أكثر من أربعة سنوات على وفاته.
عندما أتخيل موتي، هذا شيء وعندما أتخيل موت الآخرين، هذا شيء آخر. هناك موت شرعي، بموجب الشهادة الطبية التي يسلمها الطبيب الشرعي عند معاينة الوفاة؛ وهناك صيرورة الموت التي تبدأ قبل الإعلان عن الموت بشهادة الطبيب الشرعي. يشرع الجسد في الموت قبل الموت الرسمي بعد أن تشرع بعض الأعضاء في التوقف عن العمل أو عندما تبدأ التفاعلات الكيميائية في التعثر داخل الجسد؛ أو عندما يصبح الجسد عاجزا عن تمثُّل الطعام أو عن الاستفادة من الأدوية؛ وحتى بعد توقف القلب عن الخفقان تستمر بعض الأعضاء في الاشتغال، ولو بعض ساعات عند توفر شروط معينة. لذلك فإنَّ معاينة الموت من طرف الطبيب مبنيّة على معايير قانونية وليست إجابةً فلسفيّةً عن سؤال الموت، ما معناه ومتى يبدأ ومتى ينتهي. (استفدت من أبحاث Dieter Birnbacher حول أخلاقيات نهاية الحياة والموت الرحيم).
بشكل عامّ، نحن نتذوق نصيبنا من الموت في الحقيقة كل يوم بنسبة ما، بحكم أنَّ الموت لا يصيبنا دفعةً واحدةً؛ إذ تعرف الخلايا معنى الموت حينما يصيب نسبة منها بوتيرة لا تؤثر على صحّة الجسد؛ يتم تعويض الخلايا الميتة لحسن حظنا بخلايا جديدة، حفاظًا على الوظائف الأساسية، وفق توازن دقيق بين وتيرة موت خلايا وظهور خلايا جديدة أخرى.
موتي هو في الأخير نهاية حياتي، هو “وفاة” بالمعنى الذي ذهب إليه فتغنشتاين، وهو استيفاء الأجل المحتوم. لكن، لن أُصْدَمَ بوفاتي بعد وفاتي؛ وما أعلمه عن نفسي على وجه اليقين وهذا ما يمنحني شعورًا بالسكينة (لا ينتمي الموت إلى العالم، كما قال فتغنشتاين)
لن أُصدَمَ لموتي بعد موتي لكنني أصدَمُ لموت الآخرين؛ يفرض موتُ الآخر على ذهني أن يعيد تنظيم علاقته الشخصية والإنسانية بالمتوفى وأن يعيد ترتيبها. إعادة فهم الماضي في علاقته بالمتوفّى تعني القيام بتقييم جديد لصلات الوصل العلمية والعاطفية والاجتماعية التي تجمعنا به. نكتشف صفاته الحميدة التي لم نكن ننتبه إليها، نتجاوز عنه كلَّ عثراته، ونصبح أكثر تسامحًا مع الأموات أكثر ممّا نفعله مع الأحياء. نكتشف لأوَّل مرّة الصفات الحميدة التي لم تظهر على المتوفّى في حياته وظهرت بعد وفاته. كانت الوفاة دومًا فرصةً ثمينةً لإعادة الاعتبار إلى الأموات، وفرصة الإنصاف وردّ الجميل والاعتراف بشمائل المتوفّى. هذا ما قاد العشيرة الأولى لدى فرويد إلى تعظيم الآباء وإنشاء الأديان وخلق الطابوهات نتيجة الشعور بالدَّيْن تُّجاه الآباء والأجداد، وحتّى إلى شعور بالذَّنب اتّجاههم.
طقوس التأبين مناسبة لأخذ الموعظة وإعادة ترتيب أولويات الحياة من جديد بعد غياب المتوفّى. يختلط الشعور بالذنب مع طقوس التأبين، أو التّأبين في صورة التكريم.
تشغلني مفردةُ “التكريم” لأنّها ملتبسة لا سيما إذا ما كانت تأبينًا أو نعيًا؛ تختلط بالمشاعر التي بسط فرويد القول فيها؛ يختلط فيها الشعور بالذنب بتَخَيُّل أنَّ المرء لم يقم بالمبادرة الأخيرة التي كان المتوفَّى يستحقها، أو ربَّما، لم يقم بالمبادرة الأخيرة التي كان المتوفّى ينتظرها من المرء. قد ينتابه شعورٌ بالعجز عن تدارك المبادرة الأخيرة.
إذا سألتكم منذ متى تعرفون أصدقاءكم وأحبابكم وجيرانكم وطلبتكم؟ يجيب أغلبكم: منذ عشرين سنة أو ثلاثين سنة. تخيلوا أنّني كنت قد تعرّفت على المرحوم خالد بوزوبع قبل أكثر من أربعين سنة، وبالضبط سنة 1981. لا زلت أذكُرُ أنّني كنت أدرُسُ في السّنة الثّانية وكان خالد بوزوبع والمرحوم عبد الحق السّقاط وعبد الحقّ منصف يدرسون في السنة الرّابعة؛ ولا زلت أذكُرُ المرحوم محمد مساعد الذي كان حضورُهُ مألوفًا لدي داخل ردهات الكلية، وكان يدرس في السنة الثالثة في شعبة الفلسفة.
في مقابل شعبة الفلسفة، كان أصدقاء آخرون يدرسون بشعبة علم الاجتماع، وهم في السنة الرابعة، من بينهم حسن القرنفل والخمار العلمي، وكانوا قد سبقوني بسنتين في الدراسة بالجامعة.
كان الأستاذ محمد هشام، الذي انتقل بعد ذلك من فاس إلى عين الشق بالدار البيضاء، من بين الأساتذة الذين كانوا يمارسون علينا سحرًا خاصًّا، وكان ينقلنا خلال ساعات تمرُّ كالبرق من أجواء فاس الملفوفة بعبق ابن باجة وابن رشد ولسان الدين بن الخطيب إلى عاصمة الأنوار باريس؛ كان يحلّق بنا في سماء الفكر، متنقلا بين كانغيليم وباشلار وفوكو وألتوسير وغرامشي.
لا أدري هل كان المرحوم خالد بوزوبع مولعًا بالفلاسفة النيتشويين والماركسيين، ولكنّه كان مأخوذًا دون شكّ بفلسفة العلوم، وتاريخ العلوم والرياضيات والمنطق. وكان قد نشر مقالا في مجلة أقلام وهو لا يزال طالبا، وهذا ما أثار إعجابنا منذ البدء.
وعندما رجعت من فرنسا سنة 1988، اكتشفت أستاذًا باحثًا مهووسًا بالبحث إلى درجة الانقطاع عن العالم. كان متصوّفًا منقطعًا إلى عالمه المتكون من الأرقام والأعداد والمجموعات ولم يشأ أن يدخله إلا من كان كانطيًّا أو كان من أقرباء كانطور وكودل، فريجه وهوسرل. لم يكن أغلب الطلبة يمتّون إلى كانط ولا كانطور ولا كودل بصلة عائليّة، إلا فتية ألفوا لغة المنطق وصورنة العلوم وتجريد الكانطية فأجاز لهم خالد بوزوبع دخول برجه العاجي؛ مثل ذ. محمد عاقل وادريس الطراح، وهذا هو معنى الانتماء إلى الجماعة العلميّة بالنسبة إليه.
لم يكن المرحوم بوزوبع شيخًا يمنّي النفس بالحصول على مريدين، بل كان يتطلّع إلى تكوين باحثين جادّين مؤهلين للانتساب إلى عائلة هؤلاء العلماء ويتكلمون لغتهم ويطورون أفكارهم.
لم يكن المرحوم بوزوبع يطالب طلبته ببذل الجهد نفسه الذي كان يبذله، ولو أنّهم كانوا يملكون كل المؤهلات الصحية التي تساعدهم على بذل الجهود الممكنة.
لم يكن الطلبة ولا الأساتذة ولا أنا أيضا، نعلم كم كان يعاني ذهنيًّا من احتمال أن يصابَ كرسيّه المتحرك بعطب. تخيَّلوا لو أنّني قمت هذا الصباح باقتناء مئات علب دواء ارتفاع ضغط الدّم، تًحسُّبًا لانقطاعه من السّوق؛ وتخيلوا أنَّ هذا الاحتمال قويٌّ؛ آنذاك لا شكَّ في أنّني سأصاب بمكروه محتوم بسبب اختفاء الدّواء من الصيدليات؛ هذا الاحتمال الضعيف بالنسبة إلي كان هاجسًا قويًّا كان يراود المرحوم خالد بوزوبع باستمرار؛ كان يعيش هذا الضغط النفسيًّ في كثير من الحالات عندما يتخيل عطبًا في وسائل تنقله، لأنَّ تخيُّلَ عطب بالكرسي المتحرك أو بالسيارة كان يصيبه بالهلع.
لم يكن يخفي عن زوجه هذه المعاناة الصامتة؛ فكان يشاطرها لحظات التوجُّس والتخوُّف والتهيُّب من احتمالات، ماذا لو !
ظلَّ خيطُ أمل قائمًا بدومًا في ذهنه. ما دام سند الزوجة الفاضلة إلى جانبه لم يكن المرحوم يحسُّ بإعاقة. وهو لم يكن معاقًا فعلا، ما دام قادرًا على التنقُّل إلى الكلية. على سبيل المثال، ليس الأصمُّ الأبكم معاقًا، بل المشكلة فينا، لأنّنا عاجزون عن فهم لغته.
كان الراحل خالد بوزوبع يحضر الاجتماعات في بداية سنوات عمله نهاية الثمانينات وبداية التسعينات وهو يستند إلى عكازين، ويتنقل إلى قاعة الدروس دون مشكلة، وحتّى عندما كان يستعمل الكرسي المتحرّك لم يكن معاقًا بالنسبة إلي، لأنَّ الكرسي كان يضمن استقلالية الحركة.
ما كان يثير غضبه حقيقة ويشعر معه بأنّه معاق، هو حينما لم يكن يجد الولوجيّات إلى الطوابق العليا أو إلى المدرجات. وحين كنت مسؤولا عن المسلك أو الشعبة كان يُذكّرني بالقوانين الخاصة بتنظيم طرق الولوج إلى قاعة الدرس. حينها كانت الكلية تبذل جهدها قدر المستطاع لتجهيز القاعات والمدرجات، مثل مدرج باحنيني، حتّى يقوم خالد بوزوبع بعمله على أحسن وجه.
كنت أرى في المرحوم بوزوبع العالم الباحث قبل أن أرى فيه الأستاذ، وكنت أتمنى لو كانت لدينا مراكز بحث تسمح له بالتألق في مجال تخصصه بعيدًا عن قاعات الدرس. وأعتقد فعلا أنّه ممتدٌّ في شرايين الباحثين الذين تتلمذوا على يديه ونهلوا من علمه الغزير. ونتمنى أن تعمل أسرة خالد بوزوبع على نشر أعماله التي لم تعرف طريقها إلى النور وشكرا لكم.
بقلم : عزالعرب لحكيم بناني